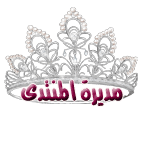النظرة اللاهوتيّة لمعضلة الموت
كُلِّفتُ أنْ أُحدِّثََكم في نظرةٍ لاهوتيةٍ عنِ الموتِ بما هو معضلة. لا يَهُمُّ العُنوانُ المُقترَح.
يبقى أنَّ الموتَ مسألةٌ عندَ كلٍّ البشرِ بسببٍ من تمسّكِهِم بهذه الحياةِ الدنيا التي بها سيتمتّعون،
ولا سيما أنّ أكثرَهم يقولون إنَّ الموتَ حقٌّ، ولعلّهم يريدون بذلك أنّه حقُّ الله على الناس.
ولكنّه في بَدءِ سِفرِ التكوينِ هو عقاب، هو كذلك بعد أن حرّم الخالقُ على جَدّينا الأوّلََين أن يأكلا من شجَرةِ المعرفةِ بقولِهِ:
إنّكما إن أكلتما منها تموتان. وأكّد ذلك بولس بقوله: “أُجرةُ الخطيئةِ هي الموت”،
بحيثُ إنّنا لا نعرفُ الموتَ إلا بعد الخطيئة، وبسببٍ منها.
اعترانا الموتُ من معصيةٍ، وكأنَّ الخلودَ هو وحدَهُ الأصلُ، ولا نعرفُ الموتَ إلا بالسقوط.
هناك طبعًا لغةُ البيولوجيةِ القائلةِ إنّ الموتَ هو حدُّ الحياةِ إذ لا بدَّ لهذا المختبرِ الكيميائي إلا أن يتشابَكَ فيه ما يُنهي عمَلََهُ ولو طال العُمر،
ولو امتدَّ الأجَلُ أربعينَ أو خمسينَ سنةً بعدَ أن يسعى إلى ذلكَ الأطباءُ في السنينَ العشَراتِ المقبلة. ولكن، لماذا يخشى الموتَ إلا النادرون من المؤمنين؟
يقول الرسول: “إنّ آخِرَ عدوٍّ يُبطَلُ هو الموتُ” بمعنى أنَّ اللهَ لا يحوِّلُه إلى صديق.
أنت، في المسيح، تدوسُهُ، مثلما داسَهُ المخلّص وَفقَ الأنشودةِ البيزنطية، أنّهُ “وطِئ الموتَ بالموت”.
لم تقل كتبُنا إنّ السيّدَ استطاب الموتَ، ولكنّها تقول إنّه غلبه، تخطّاهُ في الظفر.
نحن إزاءَه في خَشيةٍ إذ نذكرُ الخلودَ الكامنَ في صورةِ اللهِ التي فُطرْنا عليها. هذه الصورةُ لم تتصالح وضدَّها،
إذ صورةُ اللهِ فينا لا تزولُ وهي حاملةٌ طاقةَ القيامةِ التي يُفعّلُها المخلّصُ بالروحِ القدس، ما دعا الرسولَ أن يقولَ:
“أينَ شوكتُك يا موتُ؟ أينَ غلبتُكِ أيتها الجحيم”؟ تَوَقُّعُنا الموتَ يجعلُنا في انتفاضةٍ حتى نصيرَ سماويّينَ، وعلى ما قالََهُ بولسُ أيضًا:
“على صورةِ الترابيِّ يكونُ الترابيّونَ، وعلى صورةِ السماويِّ يكونُ السماويّون” أي أولئكَ التائقونَ إلى ملكوتٍ لا يفنى.
الموتُ مسألةٌ لأنّنا متأرجحونَ بين تُرابيّتِنا وسماويّتِنا حتى يفنى الترابُ فينا ونصيرَ، على الرجاءِ،
كائناتٍ من ضياءٍ حتى يفنى الرجاءُ في القيامةِ، ويحُِلُّ ملكوتُ المحبّة.
الموتُ يبقى مسألةً أو عُقدةً حتى يزولَ السؤالُ بتوقُّعاتِ أيامٍ وسنينَ نشهدُ فيها انهيارَ الجسد.
في هذا الوجودِ، لنا مِيتاتٌ كثيرةٌ تُشبهُ الموتَ الأخير. ولا نريدُ أن نُواجهَها إلا بيولوجيًا ولكن نتروحنُ إن كنَّا مؤمنينَ على أنّها لمَساتٌ إلهيّةٌ
أو انعطافٌ إلهيٌّ نسمّيه افتقادًا، بمعنى أنّ النعمةَ تحِلُّ على هذا الوجودِ المكسورِ والمُشَوّه.
والذائقونَ للهِ يُلهمُهم ربُّهم رسالةً في آلامِهم، الجسديةِ منها والنفسيةِ، ويُدنيهم منه بمعرفةِ مقاصدِهِ إن كانوا يستطيعون فهمَها.
مِيتاتٌ وتعزياتٌ تتوالى، تَكسرُ وتجبرُ حتى يُوضَعَ على أجسادِهم ونفوسِهم البلسمُ الأخير. الرجاء هو إلى ما بعد رجوعِ الترابِ إلى الترابِ،
وتحوّلِ كِيانِهم كلِّه إلى نور، ولا يَقرأُ اللهُ فيهِم إلا النور. وبعدَ أن يذوقَ الراقدونَ بالمسيحِ مرارةَ الموتِ يرتشفونَ كأسَ الحياةِ حسَبَ قولِهِ:
“لن أشربَ من نِتاجِ الكرمةِ هذا إلا أن أشربه مَعَكُم ثانيةً في ملكوتِ أبي”، وبعدَ أن تُتلى في نفوسِهم الأُنشودةُ الفصحيّةُ كاملة:
“المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور”.
هذا يقودُنا إلى القولِ أن ليس هناك لاهوتُ الموتِ كما ليس هناك لاهوتُ الخطيئة. أنت لا تكتبُ لاهوتَ النُقصانِ أو الفراغِ أو الضياع.
هناك فقط لاهوتُ النعمةِ والقيامةِ من بينِ الأموات.
لم تهتمَّ الكنيسةُ الشرقيةُ بالحديثِ عمّا تصيرُ النفوسُ إليهِ من بعدِ موت. قالت إنَّ النفوسَ في الرحمةِ،
وقالَ القدّيسونَ النسّاكُ أن لا أحدَ يدخلُ بجهادِهِ، والرحمةُ وحدَها تفتحُ أبوابَ الفردوسِ إلى أن تنقلَنا القيامةُ إلى المجدِ لنعاينَ وجهَ الله.
المُهمُّ أنّنا راقدونَ مَعَ المسيحِ وحَسب… وهذا خيرُ متكأ. الإنسانُ يموتُ في هذهِ الطبيعةِ الساقطةِ ويتعهّدُهُ اللهُ ويحتضنُه،
ويَبقى مُمطِرًا عليهِ رحَمَاتِهِ حتى يتجلّى في اليومِ الأخيرِ معَ المتجلّين. وهذا هو أيضًا تجلّي الكونِ بأسرِهِ،
حسبَما يُعلّم القديسُ مكسيموسُ المعترفُ، إذ تلطّخَ الكونُ بنا، وأخضعَهُ اللهُ للباطلِ كما يقولُ الرسولُ العظيمُ،
لكي ينسجمَ الباطلُ بالباطلِ ولا تتنافرُ الكائنات، وإذا حرّرَنا الربُّ بنورِ القيامةِ يحرِّرُ الكونَ كلَّهُ بهِ لكي لا يبقى أثرٌ للفساد،
إذ لا يكونُ اللهُ كلاً في الكلّ بمعنى الكتلةِ البشريّةِ بل يصيرُ كذلكَ في الكتلةِ الكونية. وتنكشفُ السماءُ الجديدةُ والأرضُ الجديدةُ،
كما نقرأُ في سِفرِ الرؤيا، ونكوّنُ، معَ الكونِ كلّهِ، أورشليمَ السماويّةَ الحرّةَ التي هي أمُّنا جميعًا.
غيرَ أنَّ هذا التجلّيَ لا يتِِمُّ فقط في اليومِ الآخِرِ ولكنّهُ يتحقَّقُ على الرجاءِ في كلِّ لحظةٍ نعيشُها في الإيمانِ وذلكَ في ارتباطِنا الشخصي بالمسيحِ يسوع.
تذكرونَ حديثَ السيّدِ معَ مرتا أختِ لعازرَ قبيلَ بعثِهِ عندما قالت للمخلّص: يا سيّدُ لو كنتَ ههنا لما ماتَ أخي فأجابَها: سيقومُ أخوك.
فردّت: أنا أعلمُ أنّهُ سيقومُ يومَ القيامة. قالَ لها: أنا هو القيامةُ والحياة. فلو كانَ الربُّ مكتفيًا بحدوثِ القيامةِ الأخيرةِ لما أجابَ
بهذا الجوابِ وهوَ الذي تكلّمَ في موضعٍ آخَرَ وفي سياقٍ آخَرَ على القيامةِ العامّة. إنّما أَطلقَ في حِوارِهِ معَ مرتا مفهومًا للقيامةِ جديدًا
وهوَ أنّهُ اليومَ هو باعثُ المؤمنينَ بهِ إلى الحياةِ، وهوَ يريدُهُم أن يعيشوا فيهِ، أو أن يكونوا قائمين لو كانوا فيهِ أو صارَ فيهم.
وهذا ما سيتحدّثُ عنهُ بولسُ كثيرًا. عبارةً “في المسيح” التي نحتَها الرسولُ أو العبارةُ المقابِِلَةُ “المسيحُ فيكم”
على اختلافِ الصيغِ تؤوِّنُ القيامةَ فينا حياةً جديدةً حتى أمكنَنا القولُ بناءً على النصِّ الإلهي أنّ المسيحَ نفسَهُ هوَ القيامةُ،
فيصحُّ استعارتي لقولِ الحلاج:
انا مَن أهوى ومَن أهوى أنا نحنُ روحانِ حللنا بَدَنا
فـإذا أبصـرتَنــي أبصرتَــهُ وإذا أبصرتَهُ أبصرتَنـا
وقال أيضًا:
رأيــتُ ربـّـي بعيــنِ قلبـــي فقلــتُ من أنتَ؟..
قال أنتَ
وفي اللغةِ المسيحيّةِ، هذا يُترجمُ أنّ كِياني وكِيانَ المخلّصِ باتا كِيانا واحدًا حيًّا. القيامةُ العامّةُ
إذًا مزروعةٌ فيَّ ليسَ فقط وعدًا من الربِّ ولكنْ فعلاً خلاصيًّا أعيشُهُ، كلَّ يومٍ، بالقداسة.
هذا مؤسَسٌ في قولِهِ: “مَن يأكلُ جسدي ويشربُ دمي له حياةٌ أبديّة”. القيامةُ التي تحدّثَ عنها السيدُ الى مرتا، مضافةًً
إلى الإصحاحِ السادسِ من انجيلِ يوحنا، تعني شيئينِ حسَبَ تعليمِ أوريجانس العظيم. الأول أنّ كلمةَ الإنجيلِ هي الخبزُ إ
ذ بها أصيرُ انا كلمةَ المسيحِ كما علّمَ القديس يوحنا الدمشقيّ. والأمرُ الثاني: هو الإفخارستيا التي أُصبحُ فيها جسدَ المسيح.
وإذا عرفْنا أنَّ الجسدَ عندَ العبرانيينَ هو الذاتُ الظاهرةُ، هذا يعني أنّ ذاتَ المسيحِ باتّحادِ الحبِّ، وفي السرِّ الذي لا يسوغُ النطقُ بهِ
تُصبحُ متّحدةً بذاتي، بحيثُ لا أستطيعُ أن أفرّقَ بينَ ما هوَ منّي وما هو منه. ثمّ اشربوا منه كلُّكم هذا هو دمي، يعني بها الدمَ الحياة.
هذا من العهدِ القديمِ والفلسفةِ العبريّة. حياتُهُ حياتي. هذا هو معنى الأكلِ والشربِ في سرِّ الشكر.
ولكن يعطينا القديسُ نقولاوس كابازيلاس معنىً مقابِلاً إذ يقولُ إنَّ المسيحَ في المناولةِ الإلهيةِ يأكلُنا ويشربُنا.
في هذا السياقِ أذهلني منذُ وقتٍ يسيرٍ ما أتتْ بهِ الليتورجيا البيزنطيّةُ توًّا بعدَ الاستحالة:
“ليكونَ للمتناولينَ لنباهةِ النفسِ والجسدِ وكمالِ ملكوتِ السموات”.
هذهِ عندي شطحةٌ صوفيةٌ من يوحنا الذهبيِّ الفمِ إذ الملكوتُ وَحدةُ كمالِ الذبيحةِ وانتهاؤها،
ولكنّ الذهبيَّ الفمِ لم يستطع أن يُحسَّ إلا أنّنا في شركةِ هذا السرِّ العظيمِ …
بِِتنا فوق.
بعد الذهبيِّ الفمِ بقرون، يأتي القدّيس سمعانُ اللاهوتي الحديثُ ليقولَ إنّ الإفخارستيا هي النهارُ، وفي السياقِ البيزنطي،
هذا يعني النهارَ الأخيرَ المعروفَ باليومِ الثامن. كلُّ هذا ناتجٌ عن تصوّري أنّ آباءنا هؤلاءِ رأوا قياميَّةَ الإفخارستيا، وتاليًا غَلَبَتَها للموتِ،
وعلّموا أنّ انبعاثَ أجسادِنا إنّما هوَ ثَمَرةُ الإفخارستيّا، وهذا ما حفِظَتْهُ رُتبةُ الجنازةِ عندَ الموارنة.
وعلى رَغمِ نورانيةِ التعليمِ عنِ القيامةِ علّمَنا آباؤنا النساكُ ما سمَّوه ذكرَ الموت، ناظرين إلى الجهادِ الذي تُلهمُنا إياهُ حادثةُ الموتِ
التي أمامَنا فنصبِحُ بهذا الذكر تائبين. والتوبة توبةٌ إلى وجهِ الآبِ الذي يُقيمُنا بِمحبّتِهِ للابنِ في الروحِ القدسِ الذي يُحيي عِظامَنا كما يقولُ الكتاب.
لعلَّ أهمَّ عنصرٍ للموتِ فينا أنَّ أجسادَنا تُصبحُ مُمجّدةً كما صار جسدُ المخلّصِ في اليومِ الثالثِ بحَيثُ يَحفَظُ اللهُ ما كانً أساسيًّا في كِيانِنا الأرضِي
ويُلبِسُهُ النورَ، ونتنزَّهُ عمّا كانَ في جسديّتِِنا ذا وظيفةٍ أرضيّةٍ كالطعامِ والزواج.
كيفَ نكونُ نحنُ إيانا في المسيحِ، نورُنا من نورِه، بلا ذرّةٍ من تراب؟
يقولُ القدّيسون إنّنا لا نسيرُ فقط وراءَ اللهِ ولكن في الله. هذهِ حركةٌ في السكونِ كما يقولُ مكسيموسُ المعترفُ ونحنُ في معيّةِ القدّيسين،
هذهِ هي الكلمةُ الأخيرةُ التي تدلُّ على انصرامِ الموتِ ونصبحُ كلمةَ اللهِ المحقَّقةِ، ليسَ بمعنى كلامِ الخَلقِ الاولِّ،
ولكنْ بمعنى الخلقِ الثاني المتمَّمِ في المجد. “والموتُ لن يكونَ فيما بعدُ، ولا يكونُ حزنٌ ولا صُراخٌ ولا وجعُ، لأنَّ الأمورَ الأولى قد مضت”
(رؤيا ٢٠:٤).
أن تذوقَ هذهِ القيامةَ كلَّ يومٍ هوَ أن تَكشِفَ أعماقَ سرِّ الخَلقِ وسرِّ الخلاصِ، وتُزيلَ أثرَ الموتِ إلى الأبدِ،
بقوّةِ الآبِ والابنِ والروحِ القدسِ الذي لهم معًا الإكرامُ والعزّةُ والسجودُ الى الأبد.
المطران جورج خضر