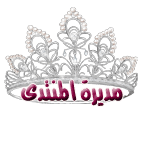العطشى الى الله
لقد غدا هذا العالم برّيّة قاحلة جرداء.
إنّه يعجّ بالناس، والناس يزحمون بعضهم بعضًا، لكنّهم كالخيالات لا يلتفت واحدهم إلى الآخر،
ولا يشعر أحدهم أنّ بقربه آخر.
فالأنانيّة تزداد والصداقات تتفتت وينابيع ماء الحياة جفّت وأصبح هذا العالم
لا يقدّم إلاّ بحاراً من المياه المالحة، أيّ الملذّات.
لقد بتنا، كما يقول داود النبي، نسلك
"في أرضٍ غير مسلوكة وعادمة الماء"،
لأنّ الله الذي هو ينبوع الماء الحيّ بات غريبًا في هذا العالم الذي نحيا فيه.
لعلّ من أجمل الرسومات الرمزيّة المسيحية القديمة هي صورة الأيائل المسرِعَة إلى نبع المياه.
ويعبّر عنها النبي داود بقوله:
"كما يشتاق الأيّل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله" (مزمور 1:42).
ويقول القديس أثناسيوس إنّ هذه الصلاة ليست لظرفٍ كظرف داود فقط،
وإنّما هي صلاة كلّ قلب عطشان إلى الله وإلى نعمته في مختلف ظروف الحياة.
إنّ العطش يعبّر عن لهيب داخلي. وهو أشدّ الأحاسيس قوّة.
وعندما تشتدّ الأحاسيس النفسيّة كثيراً تنعكس على الجسد،
ولهذا يصرخ داود في مكان آخر قائلاً:
"عطشت إليك نفسي، بكم نوع تاق إليك جسدي".
هذا يعني أنّ حبّ الله إذ يتمكّن من الإنسان فإنّه يسري حتّى في عظمه ولحمه.
فعلى الكيان أن يطلب الله. لذا، الإنسان المؤمن لا يشتاق وحسب بل يعطش أيضاً وعليه أن يطفئ لهيبه.
فإرواء هذا الظمأ وإطفاء هذا اللهيب ممكنان في الله وحده لأنّه هو المنادي للجميع قائلاً:
"مَن كان عطشانَ فلْيأتِ إليّ ويشرب" (يوحنا 37:7).
إنّ كلّ ما يُترَك طويلاً تحت أشعة الشمس يحمى كثيراً، والأمر ينطبق على النفس أيضاً.
فإن تعرّضت النفس لأشعّة ذكر الله ستزداد حرارةً وتوقّدًا بنار من غيرِ هذه الدنيا.
حينئذ تتأجّج، بل تتوهّج لهيبًا.
وهذا ما يعلّمنا إيّاه آباؤنا القدّيسون، أي أن يكون الله نهجَنا.
وأخيرًا، الكلّ يعيش في عدم الرضى، فما معنى عدم الرضى هذا؟
هذا يعني أنّه ليس في المخلوق ما يمكِنه أن يشبِع الروح.
فالروح من الله، وإلى الله تسعى، وبه تعالى تلتمس أن تأنَس،
وإذا استقرّت في شركة حيّة معه وعلى علاقة حيّة به، كانت مرتاحة إليه.
وهذا ما تعبّر عنه العبارة الشهيرة:
"يا ربّ خلقتَنا متّجهين إليك ولن نرتاح إلاّ بك".